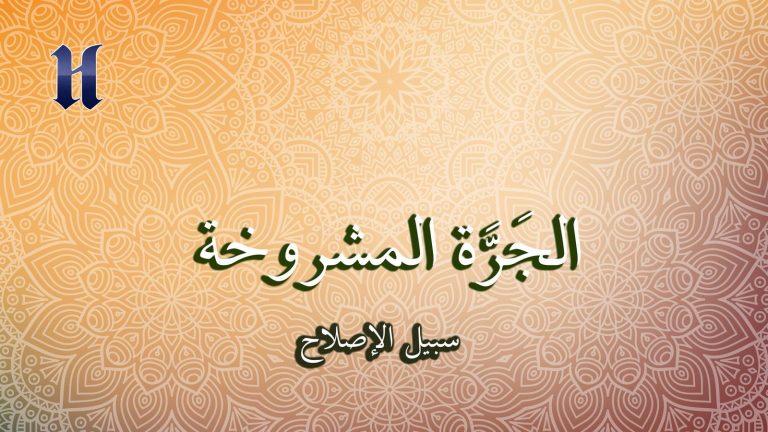سؤال: يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديثٍ شريفٍ: “إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ”[1]، فما هي الدروس المستفادة من ذلك الحديث؟
الجواب: بدايةً لا بد من بيان مدى خطإ الاعتقاد بأن تلك الأمور الخاصة بالجاهلية باقيةٌ بعينها بين أفراد الأمة المحمدية، لأن عقائد الناس في العصر الجاهلي لم تكن صحيحة، بينما عقيدة الأمة المحمدية صحيحة وحقة؛ ولذلك فإنَّه حتى وإن ظهرت تلك الأمور المتعلقة بالعصر الجاهلي بين بعض المسلمين لاحقًا فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أنَّها تختلف عن بعضها البعض من حيث الكيفية، وبتعبير آخر: فإن تلك الأمور التي جرت مجرى الدم من العروق عند أصحابها من أهل الجاهلية كانت موجودةً لديهم بمعناها الحقيقي، أما بقاؤها بين بعض المسلمين فأمرٌ مجازيٌّ أو ظليّ، وعليه فإن الصواب والأصح هو أن نفهم عبارة “لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ” على أنَّها ستبقى بحيث يجري تَغييرُها وتعديلها بطريقة أو بأخرى، لا أنْ نَفهَم أنها ستبقى بعينها تمامًا وعلى حالها الذي كانت عليه في العصر الجاهلي.
الفخر بالحسَبِ والنسَبِ سلوةٌ لا طائل منها
أول المحذورات الأربعة المذكورة في الحديث هو “الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ“، والحقيقة أنَّ افتخارَ الإنسان بأيّ أمرٍ كالمنصب والمقام والعلم والمالِ والجمالِ والذكاءِ؛ لا يُعَدُّ إلا تعبيرًا عن إساءة الأدب مع الله تعالى، وكما وردَ عن الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي فإنَّ تجاهل إحسان الله ولطفه نكرانٌ للجميل، أما عَزْوُ ذلك إلى النفس فهو فخرٌ، وإذا كان الإنسان يرغب في اجتناب هذين الأمرين وجب عليه أولًا أن يؤمن ويعتقد يقينًا بأن كلَّ النعم التي يحظى بها كالعلم والعرفان والعقل والمحاكمة العقلية والصحة والمال… إلخ من الله تعالى فقط، وأن يقرَّ بأنَّ كل تلك النعم مصدرُها الجميلُ المتعال، ثم يذكرها عندما يقتضي الأمر ذكرها من باب ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ (سُورَةُ الضُّحَى: 11/93) فحسب، لا من باب الفخر والتّيه.
وزيادة في التوضيح نقول: إن افتخار الإنسان وعجبه بنفسه أمر سيِّئ للغاية، لا يحبه الله تعالى؛ إذ ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (سُورَةُ لُقْمَانَ: 18/31)، ويسوقُ الحديثُ الشريفُ هنا نوعًا خاصًّا من أنواعِ هذه الآفةِ التي تُدَمِّرُ الإنسانَ وهو الافتخار بالحسب والنسب والأصلِ والعِرقِ وشجرةِ العائلة، ومن هذه الناحية فإنه ينبغي للإنسان حتى وإن انحدَرَ من سلالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرة النقيّة أن يقول: “اللهم إن انحداري من سلسلة نسبٍ مباركةٍ كتلك أمرٌ ليس بيدي، وإنني أعلمُ يقينًا أنك أنتَ من قَسَمَهُ لي، وهذا إحسانٌ منك وفضلٌ، وهو في الوقت نفسه مسؤولية ثقيلة بالنسبة لي، اللهم لك الحمدُ كلُّه والثناءُ كلُّهُ أن أحسنْتَ إليَّ بهذا، وإنني لأسألُك مددَك وعونك كي أستطيع الوفاءَ بحقِّ هذه المسؤولية”، غير أنه يلزمه ألا يستغلّ أبدًا مجيئه من نسب معين كوسيلة للتعالي والتكبر على الآخرين.
وإن تباهيَ الإنسانِ بآبائِهِ أو بثراءِ أجدادِهِ أو بقصورِهم ومصايفهم لَيَدْخُلُ في إطار آفـةِ الفخرِ بالحسَبِ والنَّسَبِ، وكذلك الأمرُ تمامًا بالنسبة لابن وزيرٍ ما، أو ابنِ رئيسِ وزراء، أو ابنِ رئيس الجمهورية، فهذا أيضًا من هذا القبيل، في حين أنه لا قيمة لأيٍ من تلك الأمور عند الله تعالى، بل إنّ الفخر بها أمر مردود ومرفوض عنده جل وعلا، فإن كان الشخص الواقع في مثل تلك الأمور مؤمنًا فقد يعاقَب عليها في الدنيا، وإلا فعقابُه في محكمة العدلِ الإلهيّة الكبرى، وهذا أصعبُ وأشد تنكيلًا.
وعليه فإنَّه يجب على الإنسان ألا يتدنَّى بأي شكل من الأشكال إلى هذه الدركة؛ دركةِ الفخر بالحسب والنسب، وألا يعتبر هذه الأمور تميُّزًا وتفوُّقًا؛ لأن المزايا والخصال التي كانت لأجداده لا تفيده بأيّ شيء، والأمر المهم هو أن تكون لدى الإنسان تلك القيمة الذاتية التي لفت الحقُّ تعالى الانتباهَ إليها بقوله العظيم: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (سُورَةُ الْحُجُرَاتِ: 13/49).
أجل، إن مكانةَ العبد عند الله تعالى مرتبطةٌ بدرجة طاعتِهِ وعبادتِهِ لله تعالى، وبعلاقتِهِ به جل وعلا، ومواصلتِهِ حياته في إطار “الإحسان”، وإيمانِه بأن الله يرى كل ما يفعله، بل والأكثر من ذلك أنَّها مرتبطةٌ بكونه يعمل العمل في كلِّ شيء وكأنَّه يرى اللهَ سبحانه وتعالى، ومنْ لا يراعي واجباته ومسؤولياته المنوطة به لا ينفعه أصلُهُ وفصلهُ أبدًا؛ إذ إنَّ سيدنا عمر رضي الله عنه أَبانَ بقوله: “إِنَّا قَوْمٌ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَلَنْ نَلْتَمِسَ الْعِزَّ بِغَيْرِهِ”[2] أنَّ البحثَ عن وسائل الرفعة والعزة والفضل في غير الإسلام عبثٌ وسدًى.
النظام الطَّبَقيّ داءُ الإنسانية العُضالُ
وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: “وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ” ثاني تلك الأمور الجاهلية، ألا وهو الطعن في الآخرين والتشنيع عليهم بسبب أنسابهم، فكما أنَّ نشأة إنسان في عائلة فقيرة وكونَ أبيه يعمل راعي غنمٍ لن يُفقده شيئًا فإنَّ كونه سليل فلان بن فلانٍ لن يُكسبه شيئًا أيضًا؛ إذ إنَّ المهمَّ هو امتلاكُ الإنسان لِلْقيمة الذاتية كما ذُكر آنفًا، وما أجمل تلخيصَ أبياتِ إبراهيم حقي لهذا الموقف إذ يقول مخاطبًا نفسه (ما ترجمَتُهُ العربية):
إذا أردت أن تكون ماهرًا بهذا الطريقِ
فلا تُفشِيَنْ سرَّكَ يا صديقي
ولا تَحْقِرَنْ أهلَ الخرابات يا “ذاكرُ”
فكم من خرابات بالكنوز تزخرُ
أجل، كم من أناسٍ تحسبونهم خراباتٍ وأطلالًا غير أنَّ صدورهم ملأى كنوزًا وأسرارًا.
ومن هذه الناحية فإن الطعنَ في الناس والتشنيعَ بهم بالنظر إلى المناخ الثقافي والحالة المادية التي نشؤوا فيها، والوسطِ الذي يعيشون فيه والمحيط الأسري الذي هم عليه وما إلى ذلك ليس صحيحًا ألبتة، والحقيقة أنَّ آفةَ الإحساسِ بالتفوُّقِ على الآخرين والاستخفافِ بهم ليسَت وليدة اليومِ، بل ترجع إلى عصورٍ سحيقةٍ جدًّا؛ إذ إنَّ عقيدة “النظام الطَّبَقي” التي يُقال إنّها ظهرت في الهند وإنَّ مصدرها الديانات الهندية؛ شاعَت في مجتمعاتٍ كثيرةٍ لم تحظَ بالتربية الجيّدة على يدِ الرسالات النبويّة العظيمة، ويمكننا القول: إن مثل هذا الفهم موجودٌ بمختلف جوانبه المتباينة حاليًّا أيضًا في كثيرٍ من الأماكن على وجه البسيطة بما فيها بلادنا، فإن كان النظام الطبقيُّ ما زالَ موجودًا بمختلف أشكاله ومظاهره بالرغم مما هو شائع لدى الإنسانية في يومنا هذا من مزاعم التمدّن والديمقراطية والتقدّم في حقوق الإنسان؛ فإنني أعتقدُ أنّه يجب علينا نحن عالَـمَ الإنسانية أن نُعيد النظرَ مجدَّدًا في وضعنا.
وما يتعلق بمجتمعنا من هذا الموضوع أنَّ الأناضول هو “ممرُّ الأقدام”؛ أي إنه المكان الذي اجتازته وحَلَّت به ورحلت عنه أقوام عديدة؛ إذ استقرَّ به أقوامٌ من أعراق وأديان وثقافات متباينة قَدِمَتْ من شتّى بقاع الأرض في مختلف مراحل التاريخ، وقد أسلم معظمُهم، ومن هذه الناحية فإنكم إذا هممتم تُفَتِّشون عن أصلِ ونَسَبِ أيِّ إنسان فقد تجدون بعد عدة أجيال خلت أنَّ جدَّه كان يهوديًّا أو أرمينيًّا أو نصرانيًّا أو روميًّا… إلخ، وانطلاقًا من هذا فإنه لا يحق لنا الطعن في الناس، بل إنَّ آباء معظم الصحابة الكرام رحلوا عن الدنيا ولم يتسن لهم دخول الإسلام، ولذلك فإنه يجب تقييم الناس باعتبار وضعِهم الحالي، لا باعتبار ماضيهم وأنسابهم التي ينحدرون منها.
التنجيم والخواء القلبي
وثمة أمرٌ آخر سيظلُّ بين ظهراني الأمة رغم أنه من خِصال الجاهلية، ألا وهو طلب نزول المطر من النجوم ونسبة إرساله إليها، وقد عبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله “وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ“؛ فقد كانت النجوم -لا سيما في بلاد الرافدين- تحظى بأهمّية وقداسة خاصة؛ إذ كان الناس هناك يعتقدون أن للنجومِ تأثيرًا مباشِرًا على قَدَرِ البشر، ومع أن مثل هذه المعتقدات انهارت في يومنا إلا أن الاعتقاد في التنجيم والأبراج الذي هو جانب من ذلك الاعتقاد لا يزالُ على أشُدِّه، أي إنّ هذه العادة الجاهلية ما زالت تُواصل بقاءها بأشكال مختلفة.
وفي حديث قدسيٍّ يتعلق بالموضوع ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال:
“أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ: فَأَمَّا مَنْ قَالَ “مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ” فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ “بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا” فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالكَوْكَبِ“[3].
يعني أنّه بينما يُمَثِّل حمدُ الله سبحانه وشكرُه على ذلك المطر النازلِ من السماء باعتباره أثرًا من آثار رحمة الله؛ علامةً من علامات الإيمان، فإنَّ نسبةَ المطر إلى الأسباب تمثل علامةً من علامات الشرك، أما النجوم فإن العلوم الطبيعية قد أثبتت أنه لا علاقة بين النجومِ ونزولِ المطر حتى في دائرة الأسباب.
ومما يُؤسَف له أنّ الناس حين لا يؤمنون بما يجب الإيمان به من حقائق؛ أي حين ينتفي الإيمان القوي والسليم بأركان الإيمان فإنَّ حسَّ الإيمان المفطورَ فيهم يدفعهم إلى الإيمان بالباطل؛ فيطلب بعضُهم المددَ من “اليوغا”، وبعضهم من التأمل والاستغراق، والبعض الآخر يسعى إلى إرضاء نفسه بالتنجيم، والسبب في هذا كله ليس إلا انغلاق القدرة الروحية والاستعدادات الإيمانيّة أمام الحقائق الواجب الإيمان بها، والإنسانُ بطبيعته وجِبِلَّتِهِ يركض في إثر الحقيقة، غير أنه أحيانًا ما يقع في الباطل بينما يبحث عنها؛ فيلجأُ إلى الحجرِ والشجر والنجوم التي لا تُدرك ولا تَعقل شيئًا كي يُطَمئن قلبَه المحتاجَ إلى الإيمان.
الإيمانُ بالقَدَرِ وعادةُ الحِدادِ
أما الأمر الأخير المذكور في الحديث على أنَّه “النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ” فهو المبالغة في رثاء الموتى والبكاء عليهم، وما زلنا نشهد في بعض المناطق من بلادنا مراثي يستحيل التوفيق بينها وبين المبادئ الأساسية للقرآن والسُّنة؛ إذ يجتمع الناس خلف الميت فيُعدّدون محاسنه وفضائله، ويُفرِطون في امتداحِهِ، حتى إنّهم يذكرون مثلًا محاسنَ حاجِبَيهِ، وخِلالَ ناظريه… إلخ، ولا سيما النساء فإنهن يَضْرِبْنَ بأكفِّهِنَّ على أرجلِهِنَّ ويلطمنَ وجوهَهُنَّ، ويظلَلْنَ يبكينَهُ بكاءً غيرَ حقيقيٍّ كما يفعل الممثِّلون.
في حين أنَّه لا فائدة على الإطلاق تعود على الميت من كل هذا التعظيم والتبجيل والتقدير الذي يُعدَّدُ بإضافة عباراتٍ مُبالِغَة ومصطنعة، وبغضِّ النظر عن كونها تُحَقِّقُ له فائدة أو لا؛ فإن هؤلاء بينما يرثون الميت ويبكونه تحاسبُهُ الملائكة وتسأله قائلةً: “أنت كذلك؟ أنت كذلك؟!” كما ذُكِر في الأحاديث النبوية الشريفة[4]، وبهذه الطريقة يصبح الميت عُرضةً لنوعٍ من العذاب بسببهم.
أجل، ما لم يتقرب الإنسان إلى الله تعالى بالعبادة والطاعة في الدنيا ويحسن عبادته فلن تنفعَهُ ولو مثقال ذرّةٍ كثرةُ عدد مُشَيِّعِيه، ولا المدائحُ المنظومة بحقه، ولا قولُ الجماعة المُشيّعة له “لقد كان صالحًا”[5]، علاوةً على ذلك لا بد أنْ نُبيّن أنَّ تَعَمُّدَ قول: “كان صالحًا” بحقِّ إنسانٍ فاسقٍ يعني الشهادة كذبًا، ولذلك يحاسِب الله الإنسانَ على هذا القول الكذبِ الذي نطقَ به، وهذا لا يمنعُ من إحسانِ الظنَّ بمن يرتادُ المساجد ويُصلي ويبدو خَلوقًا وفاضلًا؛ لأننا نحكُم بالظاهر، والله سبحانه فحسب هو المطَّلِع على القلوب والسرائر، إلا أن قولَ “كان صالحًا” بحقِّ من يُجاهرون بعداوة الدين والعبادة أو يختلسون ويسرقون علانيةً -لدرجة أنهم يبدون وكأنهم يُبيحون ذلك الفعل برغم أنهم لا ينفكُّون يتحدّثون عن الدين والتديُّن- ويُزَوِّرون ويفترون على الناس بالباطلِ كذبٌ مُفزِعٌ وسوءُ أدبٍ عظيمٌ تجاه الله تعالى.
أضفْ إلى ذلك أنَّه عند النظر إلى تلك المسألة من زاوية النصوص الدينية يتبيَّنُ لنا أنّ قولَ الجماعة: “نعرفه صالحًا” ردًّا منهم على سؤالِ الإمام لهم بحقِّه: “كيف تعرفون هذا الميِّتَ؟” أمرٌ لا وجودَ له في السُّنَّة السَّنِيَّةِ، وأنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَفْعَلْ مثل هذا قطّ، وأنَّ هذا أمرٌ ابتدعه المجتمع، بل إن البعضَ يُطنبونَ في هذه البدعة فيُكرِّرون السؤالَ ثلاثَ مرَّات، ثم يُضيفون سؤال: “هل سامحتموه؟”، ولكنه لا وجود لأيٍّ من هذه الأمور لا في الكتاب ولا في السُّنة ولا حتى في المصادر الفقهية؛ ولذلك فإنها بدعةٌ، لا تُفيدُ حيًّا ولا ميتًا.
ويجب أنْ نعلم أنَّه لن تضير الإنسانَ قلّةُ مُشَيِّعيه حتى وإن كان عدد من صلوا عليه صلاة الجنازة لا يتجاوز اثنين فحسب؛ طالما أنّه انتقل إلى الدار الآخرة بإيمانه وعمله الصالح، ولقد صلّى حوالي خمسة أو عشرة أشخاص صلاة الجنازة على الأستاذ “أحمد نَعيم”[6] الذي كنت أحبه وأقدِّره كثيرًا، فلما ذكرت هذه الواقعة إلى الأستاذ “يَشار”[7] ذات يوم قال لي: “أتظن أن الله تعالى يقسم لهؤلاء المذنبين أن يصلوا صلاة الجنازة على الأستاذ أحمد نعيم!” وكذلك فإنَّ الأمة قصرت في أداء واجبها تجاه محمد عاكف؛ إذ لم تذهب للصلاة عليه، ولكن طلَّابَ الجامعة جاؤوا إلى الجامع بعد أن قُضيت صلاة الجنازة حاملين الرايات ليُشَيِّعوه، والتاريخُ حافلٌ بأناسٍ كثيرين لم يُعامَلوا بقدر قيمتهم الحقيقية.
مراسم جنائز الفراعين والطواغيت
ومن ناحية أخرى فإنَّ مَنْ لم يستعد الاستعداد اللازم للآخرة وهو في الدنيا ولم ينتقل إلى الآخرة متزودًا بالأعمال الصالحة والخَيِّرَة لن يفيده أثناء انتقاله إلى لقاء الله تعالى أنْ يكون عدد مشيِّعي جنازته غفيرًا، فكم من فرعونٍ ونمرودٍ وشدَّادٍ شُيِّعَ بالملايين! غير أن هذا التَّشْيِيعَ لم ينقذهم من سوء العقابِ، وبالتالي فإنَّ أمثال هؤلاء الأشخاص لن يفيدهم أيُّ شيء أبدًا حتى وإن شَيَّعَ الملايينُ جنائزَهم واضطرَبَت الدنيا لموتهم واجتمَعَت الإنسانيّةُ جمعاء حول جثامينهم وقالت في صوت واحد: “إنا راضون عنهم”، ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (سُورَةُ مَرْيَمَ: 59/19).
والحقيقة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ“[8]، غير أن هذا الحديث النبوي الشريف قيّد الأمر بإسلام الميت، ولا يفيد أبدًا أن تلك الشهادة الكاذبة التي تؤدى بصورة الكذب عمدًا وقصدًا تنفعه.
وقد كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُذكِّرُ بالموت وما بعده ذات مرة، فقال مخاطبًا أبا ذرٍّ رضي الله عنه:
“جَدِّدِ السَّفِينَةَ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ
وَخُذِ الزَّادَ كَامِلاً فَإِنَّ السَّفَرَ بَعِيدٌ
وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَإِنَّ الْعَقَبَةَ كَؤُودٌ
وَأَخْلِصِ الْعَمَلَ فَإِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٌ”[9].
تلك هي الأمور التي أكّد وركّز عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاها أهمية وقيمة، فإن سِرتم إلى الله تعالى ملازمين دائرةً ووسطًا صالحًا كهذا وصلتم إلى أفق روحكم الطاهر النقيِّ، وشَرُفتم بحقيقة ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (سُورَةُ البَقَرَةِ: 2/156)، وإلّا فلن تعودَ عليكم بشيءٍ من النفع أبدًا تلك المراثي الـمُتَغَّنى بها، ولا المدائحُ المنمّقةُ المنظومة بشأنكم، ولا المشيعون من خلفكم وإن كانوا بالملايين.
[1] صحيح مسلم، الكسوف، 29؛ مسند الإمام أحمد، 538/37؛ الحاكم: المستدرك، 539/1 (واللفظ له).
[2] ابن أبي شيبه: المصنف، 10/7؛ الحاكم: المستدرك، 130/1.
[3] صحيح البخاري، المغازي، 37؛ صحيح مسلم، الإيمان، 125.
[4] قَالَ عليه الصلاة والسلام: “الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، إِذَا قَالُوا: وَاعَضُدَاهُ، وَاكَاسِيَاهُ، وَانَاصِرَاهُ، وَاجَبَلَاهُ، وَنَحْوَ هَذَا، يُتَعْتَعُ وَيُقَالُ: “أَنْتَ كَذَلِكَ؟ أَنْتَ كَذَلِكَ؟”، سنن ابن ماجه، الجنائز، 54. وانظر: صحيح البخاري، المغازي، 46.
[5] هناك عادة في تركيا وهي أن الإمام بعدما يصلي على الميت يتوجه إلى جماعة المصلين قائلًا: “كيف تعرفون هذا الميت؟”، ويقول الناس: “نعرفه صالحًا”، ثم يقول لهم: “هل سامحتموه؟” فيقولون: “سامحناه”.
[6] الأستاذ أحمد نعيم (1872-1934م): من العلماء الأجلاء في العهد الأخير للدولة العثمانية.
[7] الأستاذ يشار طُوناكُور (1924-2006م): واعظ ومفتٍ سابق.
[8] صحيح مسلم، الكسوف، 59؛ سنن أبي داود، الجنائز، 45.
[9] الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب، 339/5.