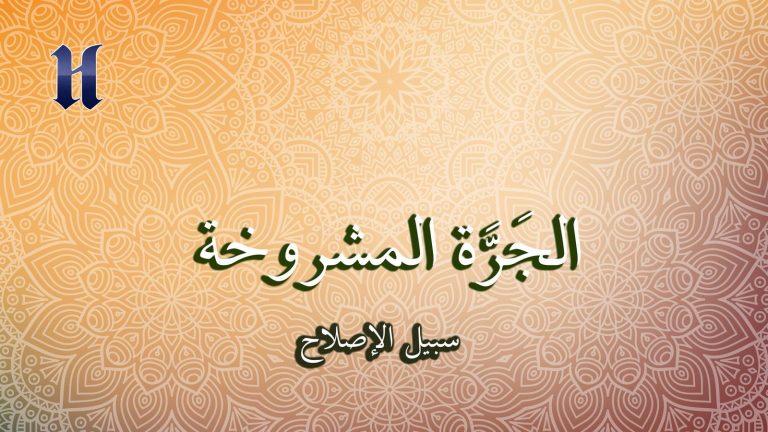سؤال: ذكرتم من قبل أن الوسائل التي تحافظ على نشاط الحياة الدينية وهي التي نسميها بـ”المؤيّدات”[1] لها ركنان مهمّان؛ أحدهما هو: “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وثانيهما: هو ما يُعرف باسم “الرقائق”؛ فهل تشرحون لنا هذين الركنين ولا سيما ما فيهما من جوانب تمسُّ عصرنا؟
الجواب: إن “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” هو دعوة الناس إلى فعل ما أمر به الدين، وتحذيرُهم مما نهى عنه، ويمكننا أن نعبر عن هذا انطلاقًا من العقيدة الماتريدية وقول فقهاء الحنفية فنقول: إنه أمرُ الناس بما حَسَّنَه العقلُ ونهيهم عمَّا قَبَّحَه العقلُ، وبتعبيرٍ آخر فإنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني نشْرَ كلِّ أمرٍ جميلٍ وحَسَنٍ وخيّرٍ بين الناس، وإثناءَ الناس عن كلِّ أمر قبيحٍ وبذيء وضارّ، وحمايتهم منه.
وظيفةٌ فرضٌ أسمى مِنَ الفرائض
ولقد استُخدمت وسائل شتّى منذ العهد النبوي الشريف من أجل تفعيل هذه الوظيفة بشكل منظّم يحتضن المجتمع بالكامل، فألقيت الخُطب والمواعظ والدروس وأقيمت حلقُ العلم ومجالسه حثًّا على ذلك، واستمرت تلك الفعاليات حتى يومنا هذا متّخذة أشكالًا وأنماطًا متباينة، وكانت الزوايا والتكايا تحتضن أكثر تلك الفعاليات نشاطًا وجذبًا وتأثيرًا؛ لأن من يعملون هناك كانوا ينادون على الأمة بأصوات قلوبهم، ويحاولون بضمائرهم التي تسبق منطقهم أن يؤثِّروا في قلوب الناس، مما أدى إلى تحقيق نفاذهم داخل أرواح مخاطبيهم بلسان “اللطيفة الربانية” و”السر” وربما بلهجة “الخفي” و”الأخفى”، وأغدقوا عليهم من الفيوضات عن أسماء الله الحسنى وصفاته و”ذاته البحت”؛ ما ضمِنَ المحافظةَ عليهم نابضين بالحياة.
ولمّا كان “الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر” من المؤيّدات المهمة التي تساعد على حماية الحياة الدينية والإبقاء عليها نابضة حيّة؛ فقد عانت الحياة الدينية من الأفول والتراجع عندما أُهملت، واستغرب الناسُ القيمَ الدينية وابتعدوا عنها، ومُنعت الجوامع أن يُذكر فيها اسم الله تعالى في فترات معينة، وفقدت وظائفها ومهمّاتها في فترات أخرى، وانساق بعض الخطباء والوعاظ إلى المواضيع العادية والتافهة في خطبهم ووعظهم، فتقلصت أهمية المنبر وقلَّ تأثيره، ولذلك فقد حُجِّم دور “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، وحُجر عليه نوعًا ما ونُحِّيَ جانبًا وكأنه قيل له: “انتظر هنا قليلًا”، وإذا نظرنا إلى فترات القحط والجدب في الفكر والمشاعر الدينية يتأكد لنا أننا ما زلنا نتخبّط ونتعثر مقارنة بما كان في عصر السعادة، حيث إن هذه المشاعر الدينيّة أُهملت في وقتنا تمامًا، ولذلك فإنَّ هذه المهمة تقع على عاتق كلِّ واحد منَّا في يومنا هذا باعتبارها فرضًا أسمى من الفرائض، وهي ديناميكيّة يستحيل أن يملأ فراغها أو ينوب عنها شيء آخر في عمليّة الانبعاث من جديد.
الرقائق: رقة القلب الذي يرتجف خشيةً
أما بالنسبة للرقائق فإنَّها تُليّن القلوب وترققها لممارسة حياة دينية سليمة خالية من النقائص والعيوب، وتُحرك روح الإنسان، وتوجه الأنظار إلى الآخرة، وتُثير القلق في القلوب استعدادًا للحساب والميزان، وهي في الوقت نفسه تشتمل على الأمور التي تُجيّشُ مشاعرَ الأمل والرجاء في القلوب، وعليه فالرقائق وسيلة إرشادية متميزة خاصة بالمؤمنين، ومن خلالها تُطرَق المسائل الخاصة بالإيمان والإسلام، ولا سيما المتعلقة بعاقبة الإنسان مثل لقائه بِمَلَكِ الموت ودفنه، وعذاب القبر، وحياة البرزخ والمحشر والحساب والميزان والصراط.
ويُعدُّ كتاب “تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين” لأبي الليث السمرقندي (ت: 373ه/985م) أحد فقهاء الحنفيّة البارزين واحدًا من المؤلفات المهمة في موضوع الرقائق؛ حيث يتناول فيه مواضيع كالإخلاص والجنة وجهنم والميزان، وقد تحدث في القسم الأخير منه عن لقاء الشيطان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما لم يُفعِّل الشيخُ أثناء تناوله لهذه الموضوعات كلّ أُسُسِ الجرح والتعديل وعلم الرجال، ولم يُعِر دراسةَ السلسلة والسند أهمّية كبرى، ولم يكن دقيقًا فيها بقدر دقة وحساسية الإمام البخاري ومسلم والنسائي، والأمر كذلك أيضًا في كتاب “إحياء علوم الدين” للإمام الغزالي؛ وذلك لأنهما لم يَرَيَا بأسًا في أن يُضمّنا كتبهما روايات ضعيفة بهدف الترغيب والترهيب.
أما الإمام القرطبي (ت: 671ه/1273م) الذي كتب في هذا الموضوع أيضًا كتابه الشهير بعنوان “التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة” فقد كان أكثر حساسية ودقة وحيطة، فمهارةُ القرطبي الذي يُعد من أعلام المذهب المالكي وحَذَقُه الظاهر في تفسيره أَمرٌ مُسلَّمٌ به، وثمة جانب آخر من جوانب شخصيته التي تُثير مشاعرَ الحيرة لدى الإنسان؛ ألا وهو وقوفه على جميع المؤلفات والعلوم التي دُوِّنت في الشرق برغم نشأته في الأندلس، ويمكن رؤية الدقة والحساسية نفسها عند أبي حيّان الأندلسي (ت: 745ه/1344م) الذي يشبهه أيضًا، فبالرغم من أنّ هذين العالمين نشآ في غرب العالم الإسلامي إلا أنهما وصلا إلى الكتب والمؤلفات التي دوّنت في بلاد إسلامية مختلفة مثل آسيا الوسطى والشام ومصر والمدينة المنورة وبغداد، ومن ثمَّ فإنَّ جهودهما الدينية والإيمانية جديرة بالتقدير والإعجاب.
وهناك الكثير من العلماء وقفوا وركزوا على المواضيع المتعلقة بالرقائق، والتي تُعتَبَرُ بدورِها واحدةً من المؤيدات المهمة لثبات الحياة الدينية وصمودها، وخلّفوا آثارًا في هذا، وكي تنعكس تلك الأمور على القلوب وتؤثّر في الأرواح يلزم بالدرجة الأولى أن يتوافر لدى المخاطبين إيمان سليم قوي، لأنه بقدر ما يرتقي الناس في مدارج الإيمان ومراتبِ اليقين يتقبلون ما قيل ودُوِّن، فيُقبلون على الحق تعالى، ويعبدونه ويطيعونه في عشقٍ وشوق إليه، ولا شك في أنّ تصرفات من اكتسبوا حساسية ودقة بهذا القدر تجاه المسائل الدينية ستولِّدُ تصرفات متميزة وفريدة للغاية تجاه المؤيدات المذكورة، وإلّا فإنّ ما يُقال من نصائح سيصطدم بحائط فولاذي، ولن يؤثر في السامعين والمخاطبين أبدًا.
مؤمنٌ حقيقيٌّ يخاف سوء العاقبة
وهنا أريدُ أن أتحدّث عن واقعتين عشتهما بنفسي علّهما تقدمان لنا فكرة في هذا الشأن؛ فقد كنت في الرابعة أو الخامسة عشر من عمري حينما وعظتُ للمرة الأولى في مسجد قريتنا، وإنني أحتارُ وأندهِشُ حين أنظر من نافذة اليوم إلى تلك الأيام؛ فكم كان أولئك القرويُّون مهذبين مؤدبين متواضعين! إذ كانوا وهم في سنِّ أبي وجدّي يستمعون لواحدٍ مثلي يصغُرهم بفارقٍ عمريٍّ كبير، وكنت أقرأُ عليهم دروسًا من كتاب “تنبيه الغافلين” في درس الظهر، ودروسًا من كتاب “درة الواعظين” في درس العصر، وكنت أحاول تفسير آيات القرآن الكريم مستفيدًا من بعض المؤلفات كالبيضاوي مثلًا، وأعرضُ لمناقب وقصص الصالحين أحيانًا؛ كلًّا حسب موضعه، أما في درس المساء فكنت أشرح لهم المسائل الفقهية من كتاب “غنية المتملّي في شرح منية المصلي” للشيخ إبراهيم الحلبي (ت: 956ه/1549م).
وقد بدأتُ الحديث عن موضوع الإخلاص من كتاب “تنبيه الغافلين”، حتى قال بعض الحاضرين “ومن يستطيع أن يتحلى بالإخلاص على هذا المستوى!” وكأنهم تأثروا وتأزمت أنفسهم تأثرًا عميقًا بشعور محاسبة النفس، لقد كان هؤلاء بقايا الجيل العثماني الذين عاشوا حتى الخمسينات من القرن المنصرم، وكان فهمهم للمسألة بهذا الشكل بتأثير ما خلفه الفهم الديني في ذلك العصر أمرًا مثيرًا للحيرة والدهشة بالرغم من أنهم كانوا يعيشون صدمات نفسية وفترة عصيبة تُحَارَبُ فيها الممارسات الدينيّة حتى كانوا وكأنهم يُضربون بمقامع من حديد، وبعد الحديث عن الإخلاص انتقلت إلى الحديث عن جهنم، وما إن مضى يومٌ أو يومان حتى بدأ البعض منهم يبكي منتحبًا.. وذات يوم عندما كنت أخرج من الجامع استوقفني شخصان ما زلت أتذكّر اسميهما، فقالا: “يا شيخ! نستحلفك بالله أليس لله جنة؟! لقد هلكنا!”، ولست أنسى ذلك الموقف بالرغم من مرور خمسين سنة عليه، ولا يزال خيال هذين الرجلين يتراءى أمام ناظريّ إلى الآن، ولما صرتُ أعظ في الجوامع الكبرى في السنوات التالية ما صادفت حتى وسط تلك الحشود إلا قلة قليلة من الناس تقابل المسائل بضمير رحبٍ واسع إلى هذا الحد.
وهذا يعني أنّ الفهم والوعي أمرٌ مهمّ جدًّا، فإن لم تكونوا تفهمون المسألة هكذا فاعلموا أنكم ما زلتم على السطح ولم تتعمّقوا في المسألة، وعليه فينبغي للإنسان أن يحمل على نفسه ما يُقال، ويُصغي إليه وكأنه موجّهٌ إليه شخصيًّا حتى تؤثر فيه تلك الرقائق، فمهمٌّ للغاية أن يُفكر الإنسانُ عند الحديث عن الجنة مثلًا أنَّها قد تكون من نصيبه، وعن النار أنه عرضة لها، فيرتعد من ذلك ويقشعرّ بدنُه، أما حين يتطرّق الحديث إلى الإخلاص فإنه يُراجع أعماله ويرتجف وينتفض خوفًا من أن يكون وقع في الرياء الذي هو الشرك الخفيّ، وإلّا فإنّ الحديث عن الرقائق والانشغال بأمثالها من المواضيع لن يُجدي نفعًا ما دام الأمر منحصرًا في مجرد القول والسماع ولم يتعدّ ذلك.
وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه نموذجٌ للإنسان المؤمن حقًّا، فدائمًا ما كان يخاف من عاقبته؛ لأنَّه يُخشى على عاقبة من لا يَخشى على عاقبة نفسه، وقد كان سيدنا عمر رضي الله عنه أيضًا يخاف دائمًا من سوء المآل والعاقبة، ومثلهما أيضًا أسود بن يزيد النخعي أحد الأئمة البارزين في مدرسة النخعي بالكوفة، فقد سيطر عليه الخوف تمامًا وهو على فراش الموت، فكان يتفصّد عرقًا، ويتغير من حال إلى حال؛ فسأله علقمة بن قيس وكان عند رأسه آنذاك: “ما هذا الجزع؟ أتخاف من ذنوبك؟” فتبسم حزينًا متألمًا وأجابه قائلًا: “مَا لِي لَا أَجْزَعُ! وَمَنْ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنِّي؟! وَاللهِ لَوْ أُتِيتُ بِالْمَغْفِرَةِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَمَّنِي الْحَيَاءُ مِنْهُ مِمَّا قَدْ صَنَعْتُهُ”[2]، ومن هنا فإن المؤمن الحقيقيّ هو الذي يبقى قلِقًا خائفًا على عاقبته.
الموت هادم اللذات
ورابطة الموت أيضًا من المواضيع التي يجب الوقوف عليها فيما يتعلّق بالرقائق، وتعني التفكير في الموت وما بعده، وتخيُّلَ وحشة القبر وظلمتِه، وتذكُّرَ المخاطر التي تنتظر الإنسان في طريق الآخرة، وانتظارَ الموت والاستعداد له في أيّة لحظة، وبتعبير آخر: رابطة الموت هي ألا يفكر المرء ويعيش على نحو: “ما زلت شابًّا، وبما أنني في العشرين من عمري الآن فأمامي ربما ستون سنة أخرى أحياها؛ فهناك من يعيشون حتى الثمانين” وإنما عليه أن يعيش معتقدًا أنّ الموت ضيفٌ لا يُدرى متى ينزل عليه؛ فيستعدّ له دائمًا، وقد قال الشاعر العربي في هذا:
الْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً * * * وَالْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَلِ
إذًا فكل ما يكسبه الإنسان حتى مجيء الموت هو جهازه الذي يضعه في ذلك الصندوق.
ومثل هذا الشعور مهمٌّ للغاية من أجل الاستعداد للآخرة، لأن الإنسان إن لم يكن قد سلك طريقًا آمنًا في الدنيا فليس من المتوقع أن يكون طريقه آمنًا في الآخرة، وبالتالي فإنه يضطر لأن يسلك في الآخرة أيضًا طريقًا محفوفًا بمخاطر كثيرة، ومن هنا فإنَّ رابطة الموت مسألةٌ مهمة تلزم الاستفادة منها وتقييمها، إذ تجعل الإنسان على صلة دائمة بالموت وتُذكره بما بعد القبر.
وإذا نظرنا إلى الملاحظات الواردة في اللمعة السابعة عشرة من كتاب اللمعات (المذكِّرة الثانية عشرة) يتبين لنا طبيعة الحساسية والدقة التي عاشها بديع الزمان سعيد النورسي في هذا الشأن قبل أن يؤلف رسائل النور؛ إذ أحكمَ قبضته على نفسه وقسى عليها، والواقع أننا حين ننظر إلى الأسس التي وضعها كلٌّ من الحسن البصري (ت: 110ه/728م) وعبد القادر الجيلاني (ت: 561ه/1165م) وأبي الحسن الشاذلي (ت: 656ه/1258م) في محاسبة النفس ومساءلتها يتضح أنهم أيضًا عاشوا هذه المشاعر والأحاسيس ذاتها.
وكما هو معلوم فإنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد نهى المؤمنين عن زيارة القبور في فترةٍ ما؛ ربما بسبب صدور تصرفاتٍ لا تليق بالقبور عن بعض الناس، غير أنه لما زال ذلك الفهم الخاطئ وانمحت علة النهي أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور فقال: “إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم الْآخِرَةَ”[3].
والحاصل أنَّ “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” والتذكيرَ الدائمَ بالموضوعات المتعلقة بـ”الرقائق” يشبهان الشرايين والأوردة بالنسبة للإنسان؛ إذ إنّ حياة الجسد كله حتى ما فيه من شعيرات مرتبطةٌ بهما، كما أنّ مواصلةَ ما في الدين من حياة وحيوية مرهونة بالوفاء بهاتين الركيزتين من المؤيدات، لأن الإنسان سيمتلك في ظلّ هذا قلبًا واعيًا حكيمًا سينشغل بعاقبته، وسيخطو كل خطوة بحذر وتيقّظ، وسيقضي كل لحظة من حياته يحاسب نفسه ويقوِّمها.
[1] المؤيدات الشرعية: هي الأحكام أو التدابير التي شُرعت لا لتنظيم علاقات الناس، وإنما لحمل الناس على طاعة أحكام الشريعة الأصلية.
[2] أبو نعيم: حلية الأولياء، 103/2-104؛ الذهبي: سير الأعلام النبلاء، 52/4.
[3] سنن الترمذي، الجنائز، 60؛ سنن أبي داود، الجنائز، 75.